المشهد العالمي.. واتساع دائرة العنف
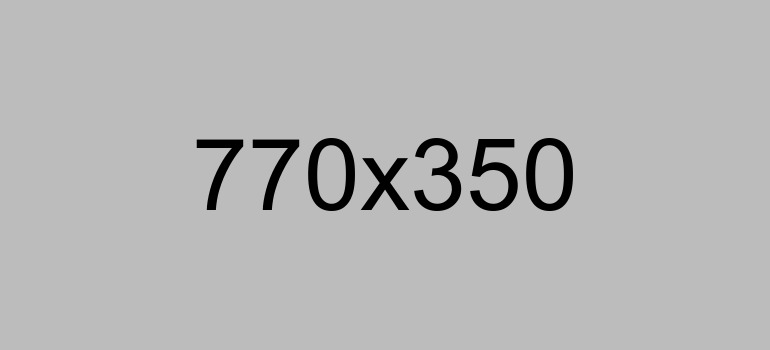
لكن رغم تزاحم الإشكالات الأمنية التي من المتوقع أن تشير إليها الوثيقتان يبرز تحدٍ واحد باعتباره الأهم والأكثر إلحاحاً ،والذي يُفترض أن يحتل مركز الصدارة في الوثيقتين الاستراتيجيتين، متمثلاً في التهديد المتنامي الذي يطرحه العنف المتصاعد عالمياً وضرورة التصدي للصراعات العنيفة قبل تفاقمها. وليس خافياً أن تزايد العنف بات التحدي الأكبر على مستوى العالم، فالصراعات الخطيرة والدموية تمتد من أفريقيا إلى الشرق الأوسط، بل وصولاً إلى جنوب آسيا، وهي كلها تنطوي على احتمالات التمدد والانتشار خارج دائرتها الضيقة إلى مناطق أوسع.
هكذا وفي الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر ببحر جنوب الصين، تعيش مناطق أخرى، مثل ميانمار وأوكرانيا على وقع الاضطرابات المقلقة، وفي جميع هذه البؤر المشتعلة، أو المرشحة للاشتعال، تبقى قدرة المؤسسات الدولية محدودة، وتظل الخيارات المتاحة أمام صناع السياسة الأميركيين قليلة وغير واضحة. فقد ساد اعتقاد على نطاق واسع بأن العنف إلى تراجع بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة، وانحسار احتمال الحرب بين القوى العظمى، ولعل ما شجع على هذا الاعتقاد ما شهدته السنوات التي أعقبت تداعي المعسكر الشرقي من التوقيع على اتفاقيات سلام وإنهاء حروب أهلية بدت حتى ذلك الوقت مستعصية، كما أن رواندا كانت قد خرجت لتوها من مجزرتها الرهيبة وشرعت في البناء، هذا ناهيك عن توقف الحرب في البلقان، وبعد أكثر من عقد على هذه التطورات التي عززت الاعتقاد في تراجع منسوب العنف العالمي جاء الرئيس أوباما إلى السلطة في الولايات المتحدة ليتعهد بإنهاء السنوات الطويلة من الحرب على الإرهاب التي تلت هجمات 11 سبتمبر، وانسحاب القوات الأميركية من العراق، فيما بدأ «الناتو» يستعد لخفض قواته في أفغانستان، لكن هذه التطورات لم تمنع من صعود العنف مرة أخرى على الساحة الدولية.
وقد بات صادماً ما يشهده العالم اليوم من توسع دائرة العنف وتزايد وتيرته على نحو غير مسبوق ليصدم العقول والضمائر، بل إن هذا الجموح في العنف يهدد المصالح الأميركية في مقتل، لا سيما المكونات الأساسية للسياسة الخارجية، سواء في جانبها الاقتصادي، مثل دعم النمو حول العالم، أو في ضمان أمن الطاقة، أو في حماية حقوق الإنسان، أو مكافحة الإرهاب والتهريب بجميع أنواعه، فهذه العناصر كلها مترابطة فيما بينها، ولا يمكن فصلها عن استتباب الأمن والاستقرار.
ولعله من المؤشرات القوية التي تؤكد تصاعد حدة العنف الأزمة السورية المستفحلة التي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 160 ألف قتيل، 50 ألفاً من المدنيين، فيما تشير الإحصاءات إلى نزوح 6.5 مليون سوري عن ديارهم بسبب الحرب، ولجوء 2.6 آخرين إلى الدول المجاورة، أما الدخل المحلي الإجمالي السوري، فقد تراجع حسب الإحصاءات بنسبة 40 في المئة منذ عام 2010، كما تشير التقديرات إلى تدمير 40 في المئة من المنازل في سوريا، ناهيك عن توافد ما بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف مقاتل أجنبي إلى سوريا للقتال إلى جانب المجموعات المتطرفة.
وبالطبع كان لاضطراب الوضع السوري دور في تأزيم الساحة العراقية، حيث لقي أزيد من 2200 عراقي حتفهم في 2014 بسبب تصاعد أعمال العنف، فيما الحكومة العراقية تجاهد لفرض الاستقرار في الفلوجة.
ولا تقتصر تداعيات الحرب الجارية في سوريا على الجوار، بل تطال المستقبل السوري نفسه متمثلاً في جيل كامل من الأطفال الذين يعانون الويلات بسبب العنف الأهوج. فحسب تقديرات الأمم المتحدة، توقف ثلاثة ملايين طفل سوري عن الذهاب إلى المدرسة، الأمر الذي دفع رئيس ائتلاف المعارضة السورية، أحمد الجربا، إلى التعبير عن مخاوفه من أن جيلاً من الأطفال غير المتعلمين سينشأ في سوريا، لا يعرف سوى لغة القوة والعنف.
وبعيداً عن سوريا تزايدت أيضاً احتمالات الحرب بين الدول، لا سيما بعد الأزمة التي افتعلتها روسيا في جارتها أوكرانيا، وإرسال قوات خاصة لمواجهة حكومة كييف، فيما يغذي التوتر بين اليابان والصين وبين هذه الأخيرة وفيتنام مخاوف الصراع المفتوح في آسيا.
هذا ولا يمكن اختزال العنف في الصراع، بل قد ينتج حسب الباحثين عن المنظومات الفاشلة التي تجعل من محاربة الفقر أمراً بالغ الصعوبة، فعلى سبيل المثال يؤدي فشل الأنظمة القضائية والأجهزة الأمنية في حماية الفقراء من تفاقم ظواهر معيبة، مثل السخرة والسرقة والنهب والاعتقال غير القانوني والاغتصاب، وبقية الانتهاكات الأخرى التي فقط تعمق الفقر وتمس كرامتهم، ما يجعل من العنف أداة من أدوات تعطيل التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر.
لكن الوعي بخطورة العنف وتأثيره السلبي على الاقتصاد والاستقرار لا يكفي وحده للحد من انتشاره، بل لا بد من تغيير الذهنيات وبالأخص المشتغلين في المجال الأمني الذين عليهم أن يعرفوا بأن الاكتفاء بالقوة لمواجهة التحديات الأمنية لن يجدي نفعاً ما لم يرافقه بناء قدرات الحوار والانخراط الفاعل مع الآخر على الصعيد العالمي، وأيضاً بذل جهد على مستوى القاعدة الاجتماعية لتنشئة حاضنات سياسية تتجاوب مع نداء السلام، وتدرك ضرورة الاستقرار لتحقيق التقدم والرخاء.
كريستين لورد
رئيسة معهد السلام الأميركي
الاتحاد الاماراتية















