الكرد بصدد الأفضل لهم
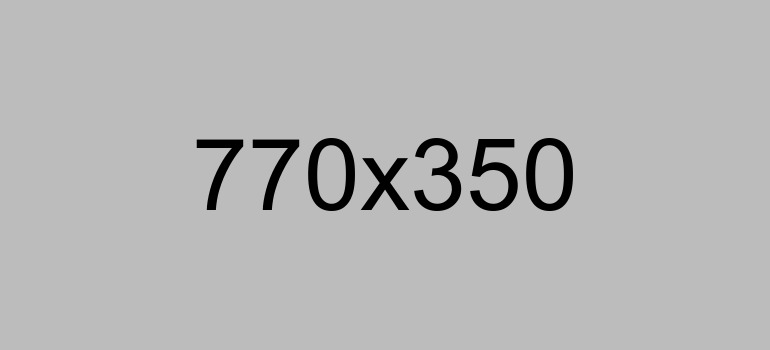
وفي عالم الذوق والجمال ينقسم العالم إلى (جميل) و(قبيح)، والجميل يمكن إظهاره بمفاتنه الذاتية أو عن طريق التجميل الشكلي والتلوين والتحسين، ولكنه ليس في صراعٍ مع القبيح الذي يمكن أن يتعايش مع الجميل، بل يمكن أن يتحول الأول إلى الثاني أو بالعكس، ويمكن أن يعيشا جنباً إلى جنب، كامرأة جميلة وزوج قبيح، وذلك يتوقف على الطاقة البشرية التي تستخدم الأدوات والألوان والقياس والترتيب بهدف التحسين أو جعل الحسن الجميل رديئاً، كما يفعل الممثلون الذين يحولون أنفسهم إلى وحوش ضارية ومخلوقاتٍ شريرة مقرفة المظاهر.
وفي عالم السوق، يتحرك كل شيء حسب قاعدة “الربح” و “الخسارة”، وهما أمران متعاكسان تماماً، وقد يتحول الرابح إلى خاسر أو بالعكس يصبح الخاسر رابحاً، ولكن يبقى القانون هو ذاته في السوق، حيث التبادل والمنافسة والمقايضة والبيع والشراء...
أما في عالم السياسة، فالإنسانية مقسمة إلى “صديق” و “عدو”، وعندما نقول الإنسانية، فإننا نعني الأمم والقوميات والدول والحكومات منها، فالإنسانية بحد ذاتها كتلة هائلة من البشر ذوي الغايات والعقائد والمصالح والطبائع والطموحات والأهداف المختلفة.
وبتحول المصالح وتطور المجتمعات وتعارض الطموحات تتغير مستويات التعارض والعداوات وكذلك التحالفات والصداقات، فإيران الشاه التي كانت قلعة للولايات المتحدة في المنطقة قد تحولت إلى دولة معادية لها، بعد احتلال الإيرانيين لسفارة واشنطن في طهران أثناء الثورة الإسلامية، وتركيا التي كانت صديقة حميمة لإسرائيل تحولت إلى معارضة لسياساتها وبدت البغضاء تفوح من أفواه زعماء الطرفين بعد حدوث مشكلة إطلاق نار على سفينة إغاثة تركية من قبل حرس السواحل الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط. وهكذا فالعدو قد يتحول إلى صديق وبالعكس بسرعة قد لا نتوقعها أبداً. وقول بعض الساسة بأن لا عداوة دائمة ولا صداقة دائمة في السياسة وإنما هناك المصالح التي ترسم أبعادها وتشكل أضلاعها وزواياها قولٌ يؤخذ به على أنه صحيح تماماً.
إنه أمر واقعي أن “العدو” ليس ذلك الذي في وضع الهجوم علينا فقط، بل كل من يمكن أن يتحول إلى مهاجم، والصديق ليس ذلك الذي له معنى علاقات فقط، ولكنه كل من نأمل في أن يصبح لنا صديقاً في المستقبل.
بعض المفكرين والفلاسفة، رأوا في تقسيم العالم إلى “عدو” و “صديق” أخطر شيء على البشرية واعتبروا هذا التقسيم سببا أساسيا لشن الحروب التي تراق فيها دماء البشر وتفسد الأرض، فسعوا إلى طرح فكرة “الدولة العالمية” التي ليس فيها حدود بين الشعوب والقوميات والأمم. ولكن كانت هناك في التاريخ امبراطوريات عظيمة، كما في الصين، وكما في روما، ودولة الخلافة الإسلامية التي تداول فيها السلطة العرب والعجم، ومنهم الكورد أثناء حكم السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، ومن ثم العثمانيون، وكذلك امبراطوريات نابليون بونابرت والتوسع الاستعماري على مساحاتٍ واسعة عن طريق الغزو والحرب، قديماً مثل غزوات المغول والتتار من الشرق باتجاه الغرب، وحديثاً التوسع النازي الهتلري عن طريق الحرب أيضاً صوب الشرق وباتجاه شمال أفريقيا وكل الدول الأوربية تقريباً، وما بين هاتين الغزوتين الكبيرتين، قيام دول استعمارية كبيرة لاتغرب عن ممتلكاتها الشمس كالاستعمار الإنجليزي ومثيله الفرنسي، أو التوغل الاسباني والبرتغالي باتجاه العالم الجديد، بحثاً عن الثروة والجاه ولتوسيع ممتلكات بلدانها وملوكها، وأخيراً نشوء دول كبيرة كالولايات المتحدة الأمريكية، والإمبراطورية الشيوعية للاتحاد السوفييتي، وشيوعية ماوتسى تونغ في الصين الشعبية، ومن بعدها محاولات بناء الاتحاد الأوروبي وسواه من الأشكال والنظم ما فوق القومية والأوسع من الرقعة الجغرافية للملة الواحدة.
من هذه الدول مافوق الدولة القومية والحدود الضيقة ما قام على أساس ديني كالخلافة الإسلامية، والحروب الصليبية، ومنها ما قام على أساس الغزو التوسعي الصارخ كالامبراطورية الرومانية والغزو المغولي والتوسع الاستعماري البريطاني - الفرنسي، ومنها ما كان على أساس آيديولوجي وطبقي كالاتحاد السوفييتي، أو على المصالح المشتركة للأقاليم والأجزاء كالولايات المتحدة الأمريكية، واتحاد المدن الألمانية الشمالية سابقاً، إلا أن كل هذه المحاولات الكبرى قد فشلت في تحقيق “الدولة العالمية”، وهذا الفشل نلاحظه بوضوحٍ تام لدى مراقبتنا لمشروع منظمة الأمم المتحدة التي تبدو عاجزة تماماً عن إنجاز مشروعها الدولي الكبير، ليس في إيقاف الحروب الناشبة فحسب، وإنما في إيقاف المجازر المروعة والجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية أيضاً، كما رأينا من قبل في رواندا ونراه الآن في سوريا مع الأسف. وكذلك فشل الاتحاد الأوربي الذي يضم ما يقارب الثلاثين دولة، إلا أنه لايستطيع تلبية مطالب هذه الدول، أو أن يحقق الرفاه المأمول لشعوبه.
هناك خلافات حادة بين العلماء والمنظرين حول إمكانية نجاح فكرة “الدولة العالمية”، في حين هناك منظمات علنية وأخرى سرية تعمل دون كلل من أجل تحقيق الفكرة في الواقع العملي، ولكن معظم هؤلاء متفقون على فكرة تجمعهم، هي أن الدولة المركزية غير قادرة على تلبية حاجات ومطالب مختلف مكونات مجتمعاتها، وهي واقعة بشكل أو بآخر تحت تأثير فئةٍ ما من فئاتها الاجتماعية، ويسهل على الدكتاتوريين وذوي النزعات الاستفرادية امتلاك ناصية القوى فيها وتسخيرها شخصياً وعائلياً وفئوياً، كما هو حال معظم الحكومات العربية المركزية في القرن الماضي، ولذا لا بد من تفتيت مراكز القوة والجبروت في هذه الدول وخلق نظمٍ (لا) مركزية، تتوزع فيها الأقاليم والأطراف قوى الدولة بين بعضها بعضاً وتحول دون قيام فئة بالسيطرة على منابع المال والسلطان لوحدها. وهذا يعني إقامة نظم ذات دساتير تسمح بمزيدٍ من الحياة الفيدرالية (الاتحادية)، الهدف منها ليس التقسيم كما يزعم أعداء اللامركزية وإنما الاتحاد على أساس التكافؤ والتضامن والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات.
وفي حال الشعب الكردي الذي عانى على الدوام من تسلط فئات عنصرية معادية له على الحكم في دولٍ مركزية، لايقف في وجه تحقيق نظامٍ فيدرالي في هذه البلدان سوى من له مصالح في الإبقاء على النظام المركزي المتشدد، ولن يطالب بتغيير هذه النظم المركزية سوى من يريد العدالة والحرية والديمقراطية والتقسيم العادل للثروات الوطنية وامتلاك أسباب القوة بالتساوي بين مختلف فئات الشعب من خلال وضع دساتير عصرية مؤمنة بحقوق الشعوب وبحقوق الإنسان، جماعاتٍ وفرادى...
لذا فإن من البديهي والطبيعي أن تكون معظم حركات الشعب الكردي السياسية وأحزابه ومنظماته مع فكرة الدولة اللامركزية وضد نظام الدولة المركزية لأنهم يسعون إلى تحقيق الأفضل لهم ولسواهم في هذه البلدان التي عانت طويلاً من عسف وجور وهيمنة النظم السياسية، وإن ما يدعم الحراك باتجاه النظم اللامركزية هو التغيير الواضح في الوعي الإنساني العام، الذي تنامى في عصرنا الحديث، بفضل التواصل الكثيف بين الجماعات البشرية والأفراد، على كل الصعد. وهذا ما يشجع الناس على تبادل الخبرات والتزود بالمعارف وبناء الشخصية الذاتية باستمرار. إن الكرد، مثل سواهم من شعوب الأرض، بصدد البحث عن الأفضل لهم، وليس هناك بأفضل من النظم اللامركزية لهم الآن. إلا أن ما يتم عرضه الآن في السوق الكردية من مشاريع، ومنها مشروع “الإدارة الذاتية الديمقراطية” في غرب كردستان لا يعني أبداً اللامركزية، بل هذا جزء من الأدوات التي قد يفكر بها النظام المركزي نفسه كمشروع “الإدارة المحلية” المطبق سابقاً في سوريا وغيرهاـ أو يسكت عنه تثبيتا لسلطته، فهنا لسنا أمام توزيع للسلطة، بل أمام تنازل طفيف لشكل مؤقت من الأدوات لصالح الحفاظ على الكل تحت قبضة النظام المركزي. وشتان بين الإدارة الذاتية الديموقراطية والإدارة اللامركزية التي تعني تقسيم مراكز القوى والسلطة في الدولة الواحدة، وثمة فارق كبير بين الفيدرالية التي يتمتع بها الكرد في جنوب كردستان وبين ما قد يتحقق عن طريق “الإدارة الذاتية الديمقراطية” التي ليست سوى إدارة “مؤقتة” حتى يتم للنظام المركزي فرض سلطانه على سائر مناطق البلاد، أو يزول ليأتي نظام آخر لايعترف للكرد بوجود... والغريب في الأمر أن ليس النظام السوري في دمشق ولا النظام التركي في أنقره، أبديا موقفاً رسمياً مما يقوم به في منطقة جيوسياسية تهم البلدين المتجاورين.
إن النظام هو المستفيد حالياً من هذا المشروع وليس المعارضة العاملة على الإطاحة به. والشعب الكردي يطمح إلى ما هو أفضل وثابت ويضمن حقوقه القومية كاملةً ومنها حق إدارة الذات وامتلاك إمكانية الدفاع عن نفسه وقدرته على استغلال ثرواته والاستفادة منها قبل غيره، وهذا يتطلب تحقيق “فيدرالية قومية كردية” لهم في كل بلد من البلدان التي تقتسم أرض وطنهم كردستان.
جان كورد
puk















